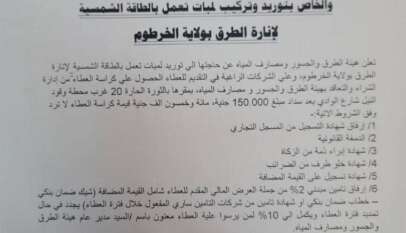فريق شرطة(حقوقي) د. الطيب عبدالجليل حسين محمود المحامي إستشاري القانون يكتب مكانة المحكمة الدستورية وإدارة القضاء في السودان(7)

تساؤلات وتعليقات وتعقيبات متابعين وردت في الفيسبوك والواتساب تناولت المقالة(5/2) المحررة بتاريخ 01 أغسطس 2025م، بطرح إستفسار عن الاحتلال التركي المصري للسودان، والاستعمار البريطاني المصري للسودان، بسؤال إستفساري هل كانت مصر دولة مستقلة وذات سيادة إشتركت في إستعمار السودان؟ والسؤال على خلفية فهم أن مصر الدولة وقعت تحت الإحتلال والإستعمار التركي والبريطاني.
وللتوضح ذات المقاله (5/ 2) أشارت إلى أن مصر الدولة، نشأت دولة تقليدية في سياق الجغرافيا والتاريخ السياسي كدولة تاريخية ذات جذور حضارية، وليست مجرد جغرافيا مرسومة باتفاقيات دولية، بل إنما نشأت من سياق حضاري سياسي ديني متصل منذ آلاف السنين لما قبل الميلاد. ورغم تعاقبت على مصر أنظمة حكم متواصلة لحقب زمنية مختلفة ومتعددة، فرعونية ورومانية وإسلامية (الفتح العربي)، وفترة الحكم المملوكي (المماليك)، والحكم العثماني(العثمانيين)، ثم محمد علي باشا، وبناء الدولة المصرية الحديثة، بعد ما حصل محمد علي باشا على فرمان وراثة الملك العثماني عام 1841م من الباب العالي العثماني في تركيا الخلافة الاسلامية، وهو ما أعطى لمصر شكل سلطنة وراثية داخل الدولة العثمانية التركية. إلا أن الدولة المصرية رغم تعاقب أنظمة الحكم المتعددة عليها، ظلت دولة محافظة على مركز سياسي حاكم في وادي النيل عبر أغلب العصور. وأنه حينما جاء الاستعمار البريطاني 1882م، وجد مصر دولة قائمة، لها مؤسسات وسلطة وسكان وهوية سياسيه، ولم يُنشئ الاستعمار البريطاني كيان الدولة (مصر) من الصفر، كما في السودان الدولة الحالية.
وتبعاً لواقع وجود الدولة المصرية جغرافيا وتاريخ سياسي، بتولّي محمد علي باشا السلطة في مصر 1805م، مصر الدولة إكتسبت استقلالاً فعلياً عن الدولة العثمانية التركيه، ولكن باعتراف اسمي بسيادة السلطان التركي العثماني. هذا الوضع القانوني والسياسي 1805م – 1882م من شكل علاقة مصر مع تركيا العثمانية يمكن وصفه بـالتحالف الكونفيديرالي غير المكتوب. وظاهر التحالف الكونفيديرالي، حافظت مصر على علاقات شكلية مع الباب العالي العثماني في تركيا الخلافة الاسلامية. برفعها علم الدولة العثمانية التركيه في مصر على مقار الدواوين والأعيان الرسمية والقلاع والسفن البحرية، للدلالة على أن مصر تابعة اسمياً للسلطان العثماني في تركيا. والاشارة لإسم السلطان العثماني، بذكر إسمه في خطبة يوم الجمعة في المساجد الكبرى في مصر، لأنه في الفقه والعرف السياسي الإسلامي، الإشارة لإسم الحاكم بذكر إسمه في خطبة الجمعة، يُعتبر إعلان شرعية سلطة الحاكم على البلاد. وكما حافظت مصر على سك العملة المتداولة في مصر، والذي يعتبر من أهم رموز السيادة، بالإبقاء على اسم السلطان العثماني منقوشاً على النقود، فكان ذلك إقراراً – ولو رمزياً – بسلطان السلطان العثماني في تركيا على مصر الدولة.
فهذه الرموز الثلاثة(راية العلم التركي الـ Flag، وذكر إسم السلطان العثماني في خطبة صلاة الجمعة، وسك العملة التركية) كانت إكسسوارات سيادية حفظت ماء وجه الدولة العثمانية الوجودي في مصر الدولة، بينما في الواقع فعلاً كانت مصر 1805م – 1882م تمارس سلطتها شبه المستقلة عن تركيا العثمانية، وهو ما يجعل العلاقة بين مصر الدولة وتركيا العثمانية أقرب إلى تحالف كونفيدرالي غير مكتوب منه إلى تبعية فعلية. فكانت مصر الدولة مستقلة فعلياً في السياسات الداخلية والخارجية، وشكلت نظامًا قانونيًا وإداريًا خاصًا بها. وبذلك كانت مصر الدولة دولة كونفيديرالية بحكم الواقع مع السلطنة العثمانية في تركيا، تمارس مصر الدولة سياسة خارجية وداخلية مستقلة عن تركيا العثمانية، بما في ذلك فرض القوانين وإدارة القضاء. وهذا الوضع السياسي القانوني في نظم أشكال الدولة، يشبه وضع الكيانات الكونفيديرالية ذات الاستقلال التنفيذي مع الاعتراف بسيادة رمزية عليا. وتأسيساً على شكل العلاقة بين مصر الدولة وتركيا العثمانية، حملة محمد علي باشا على السودان 1820م – 1821م، لم تكن وقتها الدولة العثمانية هي التي أطلقت الحملة على السودان. فقد أطلقتها مصر الدولة بقواها الذاتية العسكرية والمالية، وكما لم يُرفع العلم العثماني التركي في السودان التركي المصري المحتل 1821م – 1898م، بل رُفع العلم المصري لدولة السلطان محمد علي باشا. وبالتالي، الاحتلال التركي للسودان هو في حقيقته احتلال مصري عثماني تركي ظاهرياً، بشكل التحالف الكونفيديرالي، وليس إحتلالاً عثمانياً تركياً مباشراً.
أما الاحتلال البريطاني المصري للسودان 31 ديسمبر 1898م، بعد الاحتلال البريطاني لمصر 1882م، وحيث تم حلّ الجيش المصري لسلطة الخديوي العثماني على مصر، واستبداله بجيش جديد من المصريين، ولكن تحت قيادة ضباط إنجليز، مما أضعف الروح الوطنية للجنود المصريين، وأثر لاحقاً على قدرة مصر في إدارة السودان مع البريطانيين. فكان أن بقي الخديوي وارث العرش العثماني على مصر الدولة، وبما في ذلك نظام الحكم التركي المصري على السودان موجودين اسمياً. وظلت مصر تمارس سلطتها الإسمية على السودان التركي المصري، ولكن كانت بريطانيا هي الفاعل الفعلي في الإدارة والسيادة على السودان. إلا أن تم تقنين علاقة بريطانيا ومصر على السودان في اتفاقية الحكم الثنائي 1899م فيما يعرف إصطلاحاً بالكوندومينيوم الـ Condominium، وهو إصطلاح معرفي يستخدم في السياق السياسي والدولي، للتعبير عن حالة شكل من أشكال السيادة المشتركة، حيث تتفق دولتان أو أكثر على إدارة إقليم معين بشكل مشترك، دون أن تتنازل أي منهما عن سيادتها عليه بالكامل. ومصطلح الـ Condominium كما جاء تعريفه في القانون الدولي International Law ومعناه المصطلحي، نشير له كما جاء في قاموس اللغة الانجليزية:
A territory jointly administered by two or more sovereign powers, without dividing it into separate zones of control..
ونزولاً على التعريف الاصطلاحي لكلمة Condominium، إتفاقية الحكم الثنائي الانجليزي المصري للسودان، نصت على أن السودان يُدار من حاكم عام بريطاني، يُعيّنه الخديوي العثماني في مصر الدولة، بموافقة حكومة بريطانيا. فهذا الوضع في علاقة بريطانيا ومصر على السودان، ظاهره يشبه تحالفاً كونفيديرالياً مفروضاً بالقوة الاستعمارية على مصر الدولة. فمن حيث الشكل السودان تابع لمصر وبريطانيا ومن حيث الواقع السيادة البريطانية كانت هي المهيمنة. ودلالات نموذج الكونفيديرالية الظاهري مع مصر الدولة في النموذج المصري – العثماني والنموذج البريطاني – المصري، يعبّر عن وجود نمط من التحالفات السياسية غير المتكافئة، حيث الدولة القوية تستخدم الدولة الأضعف كواجهة قانونية في الادارة والحكم. فالسودان كان موضوعاً للنفوذ والتفاهمات الامبريالية الاستعمارية، لا طرفاً فيها (أي السودان لم يكون طرف في أي من تلك التفاهمات).
وبالتالي، السودان لم يكن مستعمرة عثمانية مباشرة، ولا مستعمرة بريطانية صِرفة، بل كان نتاجاً لصيغة سيادية مركّبة بين مصر الخديوية والدولة العثمانية أولاً، ومن ثم بين مصر الخديوية ودولة بريطانيا لاحقاً. وتبعاً له، علاقة مصر الدولة الخديوية بالدولة العثمانية التركية – ثم لاحقًا علاقة مصر بدولة بريطانيا – لم تكن علاقة تبعية مطلقة، بل تقاطعت مع مفاهيم قانونية وسياسية حديثة، مثل التحالف الكونفيديرالي غير المتوازن في السيادة والسلطة. فمصر في العهد العثماني التركي تمتعت باستقلال فعلي في إدارة شئونها الداخلية والخارجية، مع احتفاظها بالولاء الرمزي للباب العالي في تركيا، ما جعل توسّعها جنوبًا نحو السودان يأخذ طابع الاحتلال المصري بغطاء عثماني، لا الاحتلال العثماني المباشر. ثم أعادت هذه العلاقة تشكيل ذاتها في ظل الاحتلال البريطاني المصري للسودان، حين تم إعلان الـ Condominium أي الحكم الثنائي البريطاني – المصري على السودان، وهو حكم ذو طابع قانوني معقّد، يمكن وصفه بـالتحالف الإمبريالي القسري، حيث أبقت بريطانيا على دور صوري لمصر الدولة، لتبرير بريطانيا مشروعها الاستعماري جنوباً، مستندة إلى مظلة قانونية هشة، تشبه في شكلها الكونيفديرالية أحد أشكال الدول والحكم، لكنها في جوهرها علاقة استعمارية أحادية السيطرة للدولة القوية بريطانيا على الدولة الضعيفة مصر.
وفي ذات السياق، ورد تعليق يفيد أن المحكمة الدستورية الفيديرالية، لا تُفهم ضمن أجهزة الحكومة التي تدير شئون الدولة، وأن الحكومة جهاز تنفيذي يدير الدولة، أما المحكمة الدستورية الفيديرالية هي أعلى هيئة قضائية دستورية، وطبيعتها الوظيفية نفسها تتعارض مع فكرة الاداره أو الجهاز التنفيذي طبقاً لمبدأ Principle of Separation of Powers وهي وظيفة تختلف تماماً عن فكرة المعنى التنفيذي وإدارة الدولة. وللتوضيح، التعليق المداخلة متعلق بذات المقالة (5/2) والتي بدأت بإجابة إستفهامية عن موقع المحكمة الدستورية ضمن بنية الدولة(أي موقع المحكمة الدستورية ضمن هيكل الحكومة لإدارة شئون الدولة). وحيث الاجابة الاستفهامية عن وضع ومكانة المحكمة الدستورية في بنية الدولة والحكومة – أشارت بوضوح تفصيلي- أنه لفهم طبيعة الدستور والقانون الدستوري والقضاء الدستوري والقضاء العادي، وكذلك نمط إدارة القضاء والعدالة – بنظام أحادية الرأس Monistic Judiciary أو عبر نظام ثنائية الرأس Dualistic Judiciary بوجود محكمة دستورية مستقلة عن السلطة القضائية – فلا بد من الإحاطة بجملة من المقاصد الفلسفية والتوجهات الفكرية التي تُشكّل الإطار الناظم للبناء الدستوري والقانوني للدولة.
وعطفاً على الاجابة الاستفهامية للمقالة، وإشارة للتعليق المثار عن وضع ومكانة المحكمة الدستورية في بنية الدولة. فلسفة الدولة الحديثة والتعريف الدستوري الحديث للدولة، تنظر للمحكمة الدستورية لا بوصفها جهازاً إدارياً أو حكومياً، وإنما تنظر للمحكمة الدستورية كعنصرٍ مؤسسي ذي طبيعة سيادية مستقلة، لا يخضع لمنطق الإدارة، بل يخضع لمنطق الحكم القضائي الدستوري السيادي. وبيان التعريف الدستوري الحديث للدولة وفق النظرية العامة للدولة، الدولة كيان دستوري جامع لأركان أربعة: ركن مادي: ويتمثل في الاقليم (الأرض). ركن شخصي: ويتمثل في الشعب والسكان. ركن السلطة: ويتمثل في الحكومة. ركن الدستور: ويتمثل في الشرعية / الهوية القانونية وكليات القيم الموجهة من أعراف وعادات وتقاليد ناظمة لمجتمع الدولة(القيم والمبادئ فوق الدستورية). وتأسيساً على التعريف الدستوري الحديث للدولة، المحكمة الدستورية ليست من أجهزة إدارة الدولة، بل من مكوّنات بنيانها السيادي، وذلك للإعتبارات الآتية:
(أولاً) مفهوم الدولة ومفهوم الحكومة:
الحكومة هي سلطة الدولة، وتتكون من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. فهي بذلك جهاز إداري مؤسسي تتولى بتضامن مكوناتها الثلاثة تسيير شئون الدولة نيابة عن السلطة التنفيذية. أما الدولة، فهو كيان قانوني سيادي جامع لمكونات أركان أربعة (شعب، إقليم، سلطة، دستور). كما أن طبيعة الحكومة، جهاز متغير غير ثابت، يتبدل بتبدل الحكومات. بينما الدولة كيان ثابت ومستقر. ووظيفة الحكومة تنفيذ السياسات العامة، وسنّ القوانين وتطبيقها وتنفيذها. وحيث وظيفة الدولة، تحقق الكيان السيادي والهوية القانونية والسياسية.
وبالتالي، المحكمة الدستورية، لا تُعد جزءاً من مكونات الحكومة بوصفها جهازاً تنفيذياً بالمعني الفني المشاع / الشائع المتداول، بل المحكمة الدستورية هيئة دستورية قضائية مستقلة وسلطة رقابية على أعمال أجهزة مؤسسات الحكومة، تعمل بشكل سيادي داخل منظومة الدولة، ولا تعمل وظيفياً داخل منظومة الحكومة، إنما تعمل هيئة بنيوية مستقلة داخل منظومات الحكومة.
(ثانياً) المحكمة الدستورية بالنظر إليها ضمن أركان الدولة:
وفق النظرية العامة للدولة، بخلاف التعريف التقليدي الثلاثي للدولة، بأنها تتكون من أقليم وشعب وسلطة. التعريف الدستوري الحديث للدولة، يعرفها بأنها كيان تتكون من أربعة أركان أساسية: الركن المادي (الإقليم)، الركن الشخصي(الشعب)، ركن السلطة (الحكومة)، ركن الدستور(الشرعية / الهوية القانونية والقيم والأعراف والتقاليد والعادات المكتوبة في وجدان ضمير الشعب).
ومن حيث الركن المادي للدولة، المحكمة الدستورية تمارس اختصاصها داخل إقليم حدود الدولة السيادية. ومن حيث الركن الشخصي للدولة، تمثل المحكمة الدستورية التعبير القضائي الأعلى عن الإرادة الدستورية للشعب، وذلك من خلال حماية الحقوق والحريات وتفسير العقد الاجتماعي. والمحكمة الدستوري كسلطة للدولة داخل منظومة الحكومة، من خلالها يتجلى مبدأ استقلال القضاء، بالنظر إلى المحكمة الدستورية كجزء من البناء السلطوي للدولة، لكن ليس كجهاز حكومي إداري، بل كهيئة حكم قضائي أعلى مستقله. ومن حيث الركن الدستوري للدولة، المحكمة الدستورية هي الحارس النهائي للقيم فوق الدستورية، والمبادئ المؤسسة للنظام القانوني والسياسي، مثل: سيادة القانون، مبدأ المساواة، احترام الحقوق الأساسية.
(ثالثاً) موقع المحكمة الدستورية في مبدأ الفصل بين السلطات:
المحكمة الدستورية ليست جهازاً تنفيذياً، بل تجسيد لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث تمارس وظيفة رقابية مستقلة على سلطات أجهزة الدولة الثلاثة. فهي لا تدير شئون الدولة، بل تراقب مدى دستورية إدارة الشئون العامة للدولة. ويتجلى موقع المحكمة الدستورية في مبدأ الفصل بين السلطات في النظم الفيديرالية، وعلى سبيل المثال ألمانيا والهند والولايات المتحدة الامريكية، حيث تمثل المحكمة الدستورية أعلى هيئة حكم دستوري، ولا تخضع لأي سلطة أخرى داخل أي كيان للاتحاد الفيديرالي.
(رابعاً) التعاون بين السلطات وليس الفصل العضوي:
في الفقه الدستوري المعاصر، السلطة تُمارَس في إطار من التعاون والتعاضد، لا على اساس الفصل الصارم للسلطات. فالبرلمان يشرّع القوانين، لكنه يخضع للرقابة القضائية. والسلطة التنفيذية الاجرائية للحكومة، تطبق وتنفذ تشريعات القوانين، لكنها ملزمة بحدود الدستور. ومحاكم السلطة القضائية الابتدائية والاستئناف والنقض، تفصل في الخصومات والمنازعات بين أفراد الدولة، وتصدر الاحكام في المنازعات والخصومات، لكنها ملزمة بتطبيق صحيح القانون. وبينما المحكمة الدستورية في سلطتها الرقابية على سلطات الدولة الثلاثة، تفسر وتحمي الدستور، دون أن تدير الدولة أو تصنع السياسات.
فوظيفة المحكمة الدستورية، تأطيرية لا تنفيذية؛ أي أنها تؤطر عمل السلطات الثلاث ضمن القيم والمبادئ الدستورية، لكن دونما أن تشارك في الإدارة أو صنع القرار التنفيذي.
(خامسًا) المحكمة الدستورية ركيزة فوق دستورية Supra-Constitutional Institution:
في النُظُم القانونية والقضائية ذات الإرث الحقوقي المتقدم، مثل ألمانيا وفرنسا والهند والولايات المتحدة الأمريكية، المحكمة الدستورية من الحماة النهائيين للهوية الدستورية للدولة. فهي حارسة القيم فوق الدستورية، مثل الكرامة الإنسانية ومبدأ الديمقراطية والحقوق الأساسية، وتبعاً لنظرية البنية الأساسية للدستور Basic Structure Doctrine التي أرستها المحكمة العليا الهندية في قضية Kesavananda Bharati v. State of Kerala 1973، هذه القيم الدستورية لا يمكن المساس بها حتى بالتعديلات الدستورية. وتبعاً لمبدأ البنية الأساسية للدستور الـ Basic Structure Doctrine البرلمان لا يستطيع تعديل الدستور، إذا كان التعديل يمسّ بنية الهيكل الأساسي للدستور، حتى لو تم ذلك وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في الدستور. وعناصر البنية الأساسية (كما قرّرتها المحكمة العليا الهندية): سيادة القانون، الفصل بين السلطات، استقلال القضاء، الحقوق والحريات الأساسية، النظام الديمقراطي التعددي. والآثار الدستورية لمبدأ عدم المساس بالبنية الأساسية للدستور الـ Basic Structure Doctrine، تحوّلت المحكمة الدستورية من مجرد سلطة تفسيرية إلى سلطة ضامنة لبنية الدستور. ولم تكتفِ المحكمة الدستورية بالنصوص التشريعية الدستورية والقانونية، بل أسست مبادئ دستورية قضائية تُقيّد سلطة التعديل نفسها. ما يضع المحكمة الدستورية خارج إطار الحكومة بوصفها هيئة تنفيذية أو حتى مؤسسة سلطة عادية؛ بل مكون سيادي معنوي من مكونات الدولة الحديثة.
وفي المقابل المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، أرست مبدأ المحكمة الدستورية صانعة قانون Constitutional Court as Law Maker، وهذا المبدأ إستقر في الفقه الدستوري الأمريكي منذ 1803م في قضية Marbury v. Madisonبإرساء مبدأ الرقابة القضائية على أعمال الحكومة، وبمقتضاه ترسّخ مبدأ المراجعة القضائية الـ Judicial Review الذي يمنح المحكمة العليا سلطة إلغاء أي قانون أو إجراء تنفيذي مخالف للدستور. هذا التطور جعل المحكمة العليا الامريكية عملياً مُنتِجَة للقواعد الدستورية، لأن تفسيرها للنصوص الدستورية ينتج مبدأ قانون بالتفسير لقاعدة قانونية منصوص عليها في الدستور أو القانون، فأصبح التفسير للنص الدستوري بمثابة قانون واجب الاتباع Judge – made Law، كما تقرر في أحكام المحكمة العليا للولايات المتحدة الامريكية في قضايا مثل Brown v. Board of Education 1954 بأن قضت المحكمة العليا بعدم دستورية الفصل العنصري في المدارس العامة، أو كما جاء في قضية Roe v. Wade 1973 حيث قضت المحكمة العليا بحق المرأة في الاجهاض في المراحل الأولى من الحمل، مقررة بذلك المحكمة العليا توازناً في حق المرأة إتخاذها قرار الاجهاض وحقوق الجنين في الحياة والولاده والوجود. فلم تكتفِ المحكمة العليا بتفسير النصوص الدستورية، بل غيّرت الواقع التشريعي والاجتماعي، وأرست قواعد جديدة لم ينص عليها المشرّع الدستوري نصاً مباشراً. وهنا، صناعة القانون Law Making أو Judge – made Law ، لا تعني سنّ ووضع القوانين كما يفعل البرلمان، بل صياغة وتأويل المبادئ الدستورية، بحيث تكتسب قوة إلزامية كالقاعدة التشريعية.
وعليه، السمات المشتركة بين التجربتين الهندية والامريكية، يكمن في توظيف سلطة التفسير القضائي لتطوير القانون الدستوري وصياغة قواعده. بينما يظل الاختلاف في الأساس المرجعي؛ إذ تستند المحكمة الأمريكية إلى مرونة نصوص دستور مقتضب وعراقة الفيديرالية، في حين تعتمد المحكمة الهندية على نصوص أكثر تفصيلاً، لكنها وسّعت نطاق سلطتها التقديرية تحت مظلة حماية البنية الأساسية للدستور. ما أنتج اجتهاد التجربتين أثر سياسي واجتماعي لدور المحكمة الدستورية في المحكمة العليا كصانعة قانون Making Law Judge – made Law or أفرزت أثراً سياسياً واجتماعياً عميقاً. ففي الولايات المتحدة الامريكية، شكّلت الأحكام القضائية في قضايا الحقوق المدنية، والحريات الفردية، وحقوق الأقليات، أدوات إصلاحية غير مسبوقة، متجاوزة الجمود التشريعي الذي كثيراً ما فرضته الحسابات السياسية داخل الكونغرس. غير أن هذا الدور جعل المحكمة العليا عرضة لاتهامات بـالقضاء النشِط Judicial Activism، ودفع بعض القوى السياسية إلى المطالبة بإعادة تعريف حدود سلطات المحكمة العليا. أما في الهند، فقد وفّر دور المحكمة العليا كصانعة قانون، خاصة من خلال نظرية البنية الأساسية للدستور Basic Structure Doctrine، آلية حماية قوية ضد النزعات السلطوية التي قد تنشأ في ظل أغلبيات برلمانية واسعة. وفي الوقت ذاته أصبحت المحكمة العليا الهندية ساحة للصراع السياسي، إذ غالباً ما يلجأ إليها الفاعلون السياسيون، لحسم قضايا جوهرية تمس سياسات الدولة واتجاهاتها المستقبلية، ما جعلها لاعباً محورياً في صياغة المجال العام، وفي ضبط إيقاع العلاقة بين السلطات، وضمان استمرارية القيم الدستورية الأساسية. وبذلك، يتضح أن الدور التشريعي للقضاء الدستوري في هاتين التجربتين، لم يكن مجرد ممارسة قانونية تقنية، بل كان فعلاً سياسياً بامتياز، أسهم في إعادة تشكيل البنية المؤسسية للنظام السياسي، وفي إعادة صياغة قواعد اللعبة الديمقراطية على نحو مستدام.
وخلاصة وضع ومكانلة المحكمة الدستورية في بنية الدولة ضمن بنية مؤسسات الحكومة، المحكمة الدستورية ليست جهازاً من أجهزة الحكومة التي تدير شئون الدولة، بل تُعد من أهم مؤسسات الدولة السيادية، التي تجسد الركن السلطوي في أبعاده القضائية المستقلة عن بقية أجهزة مؤسسات الحكومة. وطبقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، تعمل المحكمة الدستورية بوصفها هيئة حكم دستوري، لا كجهاز إدارة وتنفيذ. وإنما المحكمة الدستورية هي الحارس للقيم فوق الدستورية التي تشكل الركن المعنوي للدولة، بما فيها العادات والتقاليد والشرعية والهوية الدستورية والتاريخية للدولة. وبذلك تتكامل المحكمة الدستورية مع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لا في إطار من التداخل العضوي، بل من خلال توازن تعاوني تعاضدي يؤسس لشرعية الدولة ويحمي بنيانها الدستوري. ولكن يثور سؤال، عن وضع ومكانة المحكمة الدستورية إذا كانت مدمجه في بنية الحكومة ضمن مؤسسات السلطة القضائية؟ أي إذا كانت المحكمة الدستورية تُدار ضمن جهاز القضاء الموحد في السلطة القضائية برأس واحد Monistic Judiciary، ولم تكون المحكمة الدستورية هيئة مستقلة عن باقي المحاكم في السلطة القضائية؟
الاجابة، رغم المحكمة الدستورية تُدار في بنية القضاء برأس واحد Monistic Judiciary، فهي لا تنفصل هيكلياً عن السلطة القضائية في الحكومة(أي المحكمة الدستورية لا تنفصل عن الجهاز القضائي العام في بنية الحكومة، كما في الولايات المتحدة الامريكية والهند وفرنسا ومصر والمغرب). إنما المحكمة الدستورية تُعد جزءاً من منظومة العدالة، وتخضع لنفس الإطار القانوني الإداري للقضاء العادي، ولكن مع بعض الإمتيازات الدستورية. وبالتالي، المحكمة الدستورية رغم الاندماج الإداري في السلطة القضائية، تبقى مختلفة في الوظيفة والطبيعة عن محاكم السلطة القضائية.
والطبيعة الوظيفية للمحكمة الدستورية داخل القضاء الموحد أحادي الرأس Monistic Judiciaryأو القضاء برأسين ثنائي الرأس Dualistic Judiciary، تمارس وظيفة سيادية فوق قضائية، تتجاوز مهام محاكم السلطة القضائية(الابتدائية، الاستئناف، النقض). فالمحكمة الدستورية تفصل في النزاعات بين السلطات، أو النزاعات الناشئة بين السلطات وبين الدستور. بينما محاكم السلطة القضائية، تفضّي وتفصل النزاعات الناشئة بين الأفراد. وكما المحكمة الدستورية تفسر النصوص الدستورية، وتفسر نصوص القانون التبعي التكميلي للدستور، وتحاكم الاحكام القضائية لمحاكم السلطة القضائية، إذا نصوص القانون أو الأحكام القضائية خالفت الدستور. بينما محاكم السلطة القضائية، تفسر نصوص القانون العادي التبعي والتكميلي لنصوص الدستور. وأيضاً وظيفة المحكمة الدستورية، أنها تراقب دستورية النصوص التشريعية للقانون. بينما وظيفة محاكم السلطة القضائية، أنها تطبق القانون. وكما المحكمة الدستورية تخضع لمنطق الرقابة الدستورية، وتؤدي الوظيفة الحارسة للنظام القانوني والسياسي للدولة. بينما محاكم السلطة القضائية تخضع لمنطق الدعوى القضائية.
وبالتالي، عندما تكون المحكمة الدستورية جزءاً من نظام القضاء الموحد Monistic Judiciary، فإنها تمارس ولايتها الدستوري ضمن إطار السلطة القضائية، بخلاف وضعها في النظم الفيديرالية حيث قد تُنشأ كهيئة مستقلة عنها(أي تكون المحكمة الدستورية مستقله عن قضاء ومحاكم الولايات). غير أن وظيفتها في جميع الأحوال، تتجاوز الفصل في النزاعات الفردية، إذ تتعلق جوهرياً بالبنية الدستورية للدولة، من حيث تحديد هوية الدولة، ورسم حدود السلطات، وضمان الحقوق والحريات الأساسية. ومن ثم، المحكمة الدستورية لا تُعد أداة من أدوات إدارة شئون الدولة التنفيذية، ولا مجرد محكمة عليا ذات ولاية استئنافية أعلى، بل هيئة قضائية دستورية ذات طبيعة سيادية، تضطلع بمهمة حماية وصيانة الإطار القانوني والسياسي الذي تقوم عليه الدولة.
وتبعاً لطبيعة وظيفة المحكمة الدستورية داخل النظام القانوني السياسي المؤسسي للدولة، تتمايز وظيفة المحكمة الدستورية عن محاكم السلطة القضائية من حيث النطاق والأثر؛ فالمحكمة الدستورية تضطلع بسلطة التفسير الملزم للنصوص الدستورية وللقوانين المكملة أو التبعية لها، وتمارس رقابة دستورية شاملة على النصوص القانونية والأحكام القضائية للتحقق من اتساقها مع أحكام الدستور، بحيث يترتب على قضائها بعدم
حديث الكرامة كالوقي ..بشاعة المجازر تهز صمت المنابر الطيب قسم السيد
يبدو أن السودان قد احكم خطته لتعزيز مساره الدبلوماسي، بنهج فاعل ومؤثر،عبر المنابر الدولية …