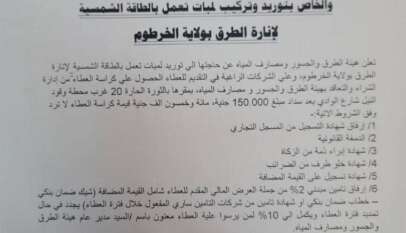وضع ومكانة المحكمة الدستورية وإدارة القضاء والعدالة في السودان (11) فريق شرطة د. الطيب عبدالجليل حسين محمود أدوات ومنهجيات المحاكم في التفسير والتأويل والتحليل لنصوص التشريعات بين قاضي المحكمة الدستورية ومستويات قاضي المحكمة العادية (1)

خروجاً عن المألوف في الدراسات النقدية والتحليلية لتشريعات القوانين وآليات تطبيقها، ومن وحي قراءات تشريعية لإصدار تشريعات القوانين وإصدار الأحكام القضائية. واستناداً إلى قراءات في فلسفة التشريع وإصدار الأحكام القضائية، فقد برزت على السطح أهمية المقارنة بين عقل قاضي المحكمة الدستورية وعقل قاضي المحاكم العادية بمختلف درجاتها.
وكما برز أيضاً مفهوم دلالات عقل القاضي ومعناه المصطلحي المتعارف عليه بالـ Judicial Mind / Legal Reasoning، ويُقصد به (مجموع المناهج العقلية الفكرية التي يعتمدها القاضي في معالجة النزاعات، وبمعنى آخر، يُقصد بعقل القاضي، المنهج العقلي والمعياري الذي يستخدمه القاضي في تفسير القانون وتطبيقه). وهذا العقل القضائي، لأهميته المحورية في هندسة وإعادة هندسية المعاملات والسلوكيات في حياة أفراد المجتمع، يتوزع إلى ثلاثة أنماط أساسية، ونوضحها كما يلي:
(1) العقل التفسيري: يركّز على فهم النصوص القانونية في سياقها، كما في المدرسة الوضعية. أي عقل يبحث في دلالة النصوص، ويطبقها حرفياً.
(2) العقل المعياري: يتجاوز النصوص إلى مبادئ العدالة، وهو ما برز في الفقه الأنجلوساكسوني، حيث القاضي لا يكتفي بتطبيق القانون، بل يطوّره عبر السوابق القضائية.
(3) العقل الإنشائي: وهو عقل يبتكر حلولاً جديدة، ويظهر خصوصاً في المحاكم العليا في محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عند معالجة الفراغ التشريعي أو التصادم بين النصوص. أي أنه عقل قضائي، يتجاوز النصوص التشريعية إلى مبادئ العدالة، كما هو في اجتهادات المحاكم العليا في الأنظمة الأنجلوساكسونية.
وكما يبدو من تدرج القاضي في مستويات درجات التقاضي، أنه يؤدي إلى تحولات واضحة في طبيعة عقل القاضي، ونشير لها من حيث الآتي:
(1) قاضي محكمة الموضوع Trial Court : يغلب عليه العقل الواقعي التجريبي، المرتبط بفحص الوقائع والأدلة – عقل الوقائع fact-finding mind- أي بمعنى آخر، قاضي محكمة الموضوع عقله واقعي تجريبي، يعتمد على الوقائع والأدلة.
(2) قاضي محكمة الاستئناف Appeal Court : يتسم عقله بالموازنة، إذ يراجع الوقائع والقانون معاً بدرجة وسطى. فهو عقل موازن، يراجع الوقائع والقانون جزئياً، وبذلك هو عقل المراجعة الجزئية (Review mind).
(3) قاضي محكمة النقض Cassation Court : يتجسد فيه العقل التجريدي القانوني، فهو عقل القانون (Mind of law)، الذي يركز على سلامة تطبيق القانون وصحة التفسير والتأويل للنصوص التشريعية في إطار القانون، وبمعنى آخر، عقله تجريدي قانوني، يركز على سلامة تطبيق القانون.
(4) قاضي دوائر المراجعة والفحص في المحكمة العليا Review and Examination Court : هو عقل ما وراء النقض (meta – review mind)، ويمثل أي منهم عقلاً فوقياً استثنائياً، يتعامل مع قضايا العدالة غير العادية، ويضطلع بدور حاسم في صيانة الأمن القانوني، عبر إصدار أحكام وقرارات نهائية ملزمة. فعقلهما استثنائي فوقي، يتعامل مع حالات العدالة الاستثنائية.
وتأسيساً على ما أشرنا إليه من تفصيلات العقل القضائي، يقوم عقل قاضي المحكمة الدستورية على مرتكز رقابيٍ (الرقابة الدستورية)، بأن يجعل من الدستور، المرجعية العليا، ومصدر المشروعية للنظام القانوني بأكمله. فلا ينصرف قاضي المحكمة الدستورية إلى تمحيص الوقائع أو وزن البينات على نحو ما يفعله القاضي العادي، فهو لا ينظر في الوقائع، ولا ينظر في الأدلة، ولكن الواقع العملي من باب الاستئناس والإستدلال بالوقائع وأدلة البينات، قاضي المحكمة الدستورية ينظر في ملف الدعوى الدستورية، لمراقبة دستورية عملية التفسير والتأويل والتحليل لنصوص التشريع، إن أوفت معايير المحاكمة العادلة. فينصرف عقل قاضي المحكمة الدستورية إلى فحص النصوص القانونية والأحكام النهائية، من زاوية مدى توافقها مع الدستور والمبادئ الدستورية الكلية، مثل سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات الأساسية. وبما أنّ وظيفة القاضي الدستوري في التفسير والتأويل للنصوص التشريعية، تتجاوز الحرفية اللغوية إلى استحضار قيم العدالة والحرية والمساواة، فإنّ عقل قاضي المحكمة الدستورية، يجد مرجعيته الفلسفية في المدرسة القيمية الطبيعية Natural Law School، التي ترى أنّ القانون لا يُفهم في معزل عن القيم الأخلاقية والحقوق الجوهرية للإنسان. وأن عملية إجراءات التفسير والتأويل للنصوص التشريعية، يجب أن تتم في إطار مقاصد العدالة، لا في حدود ألفاظ النصوص فقط. وبذلك، يصبح القاضي الدستوري هو حارس الشرعية الدستورية، الذي يقوّم ويراقب النصوص التشريعية والأحكام القضائية وقرارات الحكومة بميزان القيم والمبادئ العليا، ويستأنس بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، لتدعيم تفسيره وتأويله القيمي للنص الدستوري.
وعلى النقيض، كما تم تفصيله عن عقل القاضي، يتحدد عقل قاضي المحكمة العادية في نطاق القانون العادي، الذي يصدر عن السلطة التشريعية. ويستند في عمله إلى الإجراءات والنصوص الموضوعية المقرّرة للفصل في النزاعات المدنية والجنائية والإدارية. وعلى ضوء عقل قاضي المحكمة العادية، فإن وظيفته هي إنزال القانون على الوقائع الماثلة أمامه من خلال تقييم الأدلة والقرائن والشهادات، وإعمال النصوص النافذة دون تجاوزها أو البحث عن قيم تتجاوز مضمونها. ومن ثمّ، عقل قاضي المحكمة العادية في مستويات درجاتها، يجد أساسه الفلسفي في المدرسة الوضعية التطبيقية Legal Positivism، التي تفصل بين القانون والأخلاق، وترى أنّ القاضي ملزم بتطبيق النصوص التشريعية كما وردت، بصرف النظر عن عدالتها أو انسجامها مع المبادئ الدستورية، طالما أنّها لم يُقضَى عليها بعدم دستوريتها بالطعن فيها دستورياً. وبذلك، يظل القانون العادي هو المرجعية المباشرة لعمل القاضي العادي، ولا يستحضر استدعاء الدستور، إلا عند إثارة الدفع بعدم الدستورية في سياق الدعوى.
وبذلك يتضح أنّ التباين بين عقل القاضي الدستوري وعقل القاضي العادي، ليس تبايناً وظيفياً فحسب، بل هو انعكاس لاختلاف فلسفي عميق: فالأول (قاضي المحكمة الدستورية)، يجسد المنطق القيمي للقانون الطبيعي، حيث يُفهم النص التشريعي في ضوء مقاصده الكليه العليا، وأثره في صيانة النظام الدستوري الشامل للنظام السياسي والعدلي. بينما الثاني (قاضي المحكمة العادية) يجسد المنطق الوضعي التطبيقي للقانون، حيث يُفهم النص التشريعي باعتباره قاعدة نافذة ملزمة، تُطبق على الوقائع كما هي. ومن هنا يتكامل العقلان في بنية النظام القضائي؛ أحدهما (أي قاضي المحكمة الدستورية)، يحرس المشروعية الدستورية الكلية، والآخر (أي قاضي المحكمة العادية)، يصنع العدالة الفردية اليومية.
وفي سياق البحث في التمايز والتباين بين عقل قاضي المحكمة الدستورية وعقل قاضي المحاكم العادية بدرجاتها المختلفة، لفت انتباهي ما صاغه الفرنجه (الفكر الغربي والآسيوي في شبه القاره الهندية) حول دور المحكمة الدستورية كصانعة للتشريع (The Constitutional Court as Law Maker) – وقد سبق الإشارة إليه في حيز مقالة سابقه، ولأهميته التوضيحية، نشير للمبدأ بشيء من التفصيل – وهو ما عُرف في الفقه القضائي الأمريكي بنظرية Judge – Made Law / Court – Making Law.
فقد مارست المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية دوراً محورياً في تطوير القانون من خلال اجتهاداتها القضائية، خاصة في مجال الحقوق المدنية والحريات العامة وحقوق الأقليات، على نحو ما برز من معالجات، أقرتها المحكمة العليا الأمريكية، كما جاء في قضية براون/ ضد/ مجلس التعليم (Brown v. Board of Education, 1954): حيث قضت المحكمة العليا بعدم دستورية الفصل العنصري في التعليم العام، مؤكدة أن عدم المساواة في التعليم، يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون، فهو حق متساوي للجميع دون تمييز. وكذلك قضية رو /ضد/ ويد (Roe v. Wade, 1973)، والتي اعترفت بحق المرأة في الإجهاض ضمن نطاق الحق في الخصوصية، وهو حكم أحدث تحولاً عميقاً في النقاشات الحقوقية والاجتماعية، والحكم إلتزم جانب إحداث التوازن في حق الاجهاض للمرأة في زمن معين من أشهر الحمل الأولى بالجنين، وحق الحياة للمولود في رحم المرأة، أن يولد المولود حياً. وقضية لوفينغ ضد فرجينيا (Loving v. Virginia, 1967)، التي أبطلت القوانين التي تحظر الزواج بين الأعراق المختلفة، باعتبارها مخالفة للتعديل الرابع عشر للدستور. وقضية أوبيرغفيل ضد هودجز (Obergefell v. Hodges, 2015)، التي اعترفت بالحق الدستوري في الزواج بين الأشخاص من نفس الجنس (زواج المثليين/ اللواط ذكر ذكر والسحاق أنثى أنثى ).
وبموازاة اجتهادات المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية، صاغت المحكمة العليا الهندية، نظرية البنية الأساسية للدستور، فيما يعرف إصطلاحا بالـ Basic Structure Doctrine أو الـ Constitutional Basic Structure كآلية وقائية للحد من النزعات السلطوية المترتبة على هيمنة الأغلبية البرلمانية، ما جعل المحكمة العليا الهندية ساحة للصراع السياسي والفصل في القضايا الجوهرية المؤثرة في سياسات الدولة واتجاهاتها المستقبلية. وهي نظرية دستورية نشأت في الفقه والقضاء الهندي، ثم امتد تأثيرها إلى بعض الأنظمة الدستورية الأخرى. وجوهر النظرية، يتمثل في أن للدستور (بنية أساسية جوهرية)، لا يجوز للمشرّع الدستوري أو السلطة التأسيسية المختصة (البرلمان عند تعديله للدستور)، أن تمسّ البنية الأساسية للدستور أو تغيّره، حتى لو اتبعت الإجراءات الشكلية الصحيحة للتعديل.
ونشأت النظرية في قضية كيسافاناندا بهارتي/ ضد/ ولاية كيرلا (1973)، حيث أقرّت المحكمة العليا الهندية (لأول مرة) أن سلطة البرلمان في تعديل الدستور، ليست مطلقة، وأن هناك قيوداً موضوعية، تحمي البنية الأساسية للدستور. والنظرية جاءت كرد فعل لمحاولات السلطة التنفيذية والبرلمان توسيع سلطاتهما على حساب القضاء والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والقانون. ومضمون النظرية، البنية الأساسية للدستور، تعني مجموعة من المبادئ الجوهرية، التي يقوم عليها الدستور، ولا يمكن تعديلها أو إلغاؤها، ومن أهمها (سيادة الدستور Supremacy of the Constitution، الفصل بين السلطات Separation of Powers، الطابع الجمهوري والديمقراطي لنظام الحكم وشكل الدولة، حماية الحقوق والحريات الأساسية، سيادة القانون Rule of Law، استقلال القضاء، النظام الفيدرالي (المنصوص عليه في الدساتير الفيدرالية).
وبهذا تصبح كل من المحكمة العليا الأمريكية والهندية، لاعباً محورياً في صياغة المجال العام السياسي والاجتماعي والاقتصادي المعني بها جهاز إدارة الدولة (الحكومة)، وضبط العلاقة بين السلطات، وضمان استمرارية القيم الدستورية الأساسية. وتأسيساٌ عليه، يتضح أن التفسير والتأويل الدستوري للنصوص التشريعية في الدستور والقانون، ليس مجرد ممارسة قانونية تقنية، بل هو فعل سياسي وفكري بامتياز، يسهم في إعادة تشكيل البنية المؤسسية للنظام السياسي الداخلي للدولة، ويسهم في صياغة وإعادة صياغة قواعد اللعبة الديمقراطية بشكل مستدام.
وبما أن الأدبيات المعرفية وأكاديميات العلوم السياسية وعلوم القانون، تقرر وتفيد أن التشريع صناعة علم وفن معرفي، يقوم على قواعد علمية ومنهجية دقيقة، تهدف إلى معالجة المشكلات المستعصية التي لا حلول لها، إنما الحدّ والتقليل منها من خلال النصوص التشريعية للقانون. وحيث التشريع صناعة علم وفن معرفي، يعتمد على تراكم المعارف والخبرات العملية لمعالجة النشاط الإنساني المتطور في سياق محدودية الموارد وتعقيدات احتياجات المجتمع. فإنه، وبالموازاة مقابلة، الأحكام والقرارات القضائية أيضاً صناعة علم وفن معرفي، ومن خلال الاحكام والقرارات القضائية، تتمكن الدولة من الحدّ والتقليل من النزاعات وحلّ معضلات المشاكل الناشئة بين الافراد في المجتمع، بإصدار الأحكام والقرارات القضائية، ومنهجيتها الآدائية استخدام أدوات التفسير والتأويل للنصوص التشريعية القانونية، بما يشمل التحليل النصي للقاعدة التشريعية، والسياق التاريخي والتشريعي، والمقاصد القانونية الكلية النفعية (جلب المنفعة ودرء المفسدة)، واستخدام أدوات المعايير الفقهية، والرجوع إلى السوابق القضائية، لضمان حماية المبادئ العليا وتحقيق العدالة الواقعية.
وتبعاً عليه، يمكن القول، الاحكام والقرارات القضائية التي تصدرها المحكمة الدستورية والمحكمة العليا في دائرة النقض ودائرة المراجعة ودائرة الفحص، درجة من درجات التشريع، ومصدر من مصادر التشريع ومكمل له. والذي يُحمد للمحكمة الدستورية في السودان، إصدارها حكم لها قيودات بالنمرة:م د/ق د/ 07/ 2001م، مجلة المحكمة الدستورية للأعوام 1998م – 2003م. وأيضاً الحكم الدستوري قيودات بالنمرة:م د/ ق د/ 11 / 2001م، مجلة المحكمة الدستورية للأعوام 1998م – 2003م، لتقريرها، مبدأ خروج أحكام المحكمة العليا عن قواعد المشروعية، لإمتناعها عن تطبيق قاعدة قانونية قررها القانون، ولإمتناعها عن تطبيق مبدأ قضائي مأخوذ من قاعدة قانونية قررتها السوابق القضائية.
أي إمتناع المحكمة العليا عن تطبيق مبدأ قررته المحكمة الدستورية مأخوذ من قاعدة قانونية منصوص عليها في القانون، يبطل حكم المحكمة العليا. وتقرير المحكمة الدستورية في حكم لها قيودات النمرة:م د/ق د/ 24 /2001م بتاريخ 10 /06 /2001م، مجلة المحكمة الدستوردية للعام 1998م – 2003م، إرسائها مبدأ حسم الدعوى دون الخوض في المسألة الدستورية، مرددة قولها: إذا كان هنالك طريقة لحسم الدعوى دون الخوض في المسألة الدسـتورية، فينبغي إتبـاع ذلك الطـريق، وهذا ما يسـمى في الفـقه الدسـتوري الأمريكي بتحـاشي القرار الدستوري Avoidance of the constitutional issue.
أي قول المحكمة الدستورية، امكانية حسم وإنهاء النزاعات أمام القضاء العادي، بأن تراجع دائرة المراجعة في المحكمة العليا أحكامها بتشكيل دائرة مراجعة لمراجعة حكم أصدرته دائرة المراجعه (أي مراجعة المراجعة)، وتشكيل دائرة فحص، لفحص أحكام دائرة المراجعة في المحكمة العليا. وتأكيداً له، نشير لما قررته المحكمة القومية العليا في السودان في حكم لها غير مسجل في قائمة سجل قضايا المحكمة القومية العليا — سبق الاشارة إليه ضمن سلسلة هذه المقالات، ولأهميته نعيد الاستهداء به — والحكم يحمل قيودات النمرة:م ع/ ط م/ 2166 / 2016م /مراجعة / 474/ 2017م بتاريخ 07/ 07/ 2018م جمال مرقص/ضد/ ورثة مكرم مرقص وآخر، وأيضاً الحكم بذات النمرة والأطراف تم تقديمه للمحكمة القومية العليا كطلب لمراجعة حكم دائرة المراجعة، وتقديم طلب المراجعة لمراجعة المراجعة تاريخه 04 /11 / 2020م قيودات المحكمة القومية العليا، وفصلت فيه المحكمة القومية العليا دائرة المراجعة، بجواز مراجعة المراجعة. لإعتبار الواقع العملي بالسوابق القضائية، قرر مبدأ قضائي مأخوذ من قاعدة قانونية، أرست قاعدة قانونية تقضي بفحص الأحكام ومراجعتها. وبذلك المحكمة القومية العليا أرست بالسوابق القضائية، مبدأ مراجعة المحكمة العليا لأحكام المراجعة الصادرة من دائرة المراجعة.
وبذلك، يظهر أن التشريع والحكم القضائي منظومتين متكاملتين، كل منهما يعتمد على منهجية علمية وفنية، لحل معضلات المشاكل الناشئة بين الأفراد في المجتمعات الانسانية، مع اختلاف الأدوات بحسب طبيعة النص التشريعي والمستوى القضائي، سواء في المحكمة الدستورية أو المحاكم العادية. وللمزيد راجع في ذلك، فريق شرطة (حقوقي) دكتور/ الطيب عبدالجليل حسين محمود (المحامي إستشاري القانون والموثق)، كتاب: التشريع وصناعة القانون – المفهوم والمنهجيات والنظريات والتطبيق – (رؤية مفتاحية عن السياسة والقانون)، المؤسسة العربية المتحدة للنشر والتوزيع، مصر/ القاهرة/ الجيزة/ فيصل شارع القناوي، الطبعة الأولى، 2025م.
وللحديث بقية، نتناول فيه إضاءات معرفية عن أدوات ومنهجيات المحاكم في التفسير والتأويل والتحليل لنصوص تشريعات الدستور والقانون بين قاضي المحكمة الدستورية ومستويات قاضي المحكمة العادية، لإصدار الاحكام والقرارات القضائية، إنطلاقاً من مفهوم التشريع وصناعة القانون.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي إستشاري القانون والموثق
27 أغسطس 2025م
فكة ريق الضيف عيسي عليو لُحمة الشعب السوداني و رتق النسيج الإجتماعي
aldifaliu1961@gmail.com مناشدة لسيادة رئيس مجلس السيادة و القائد العام للقوات المسلحة السو…